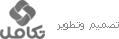قامت الدولة الوطنية العربية الحديثة- بشكل عام – بعد الاستقلال على فكرة المركزية التي تتحكم بموجبها العاصمة بالأطراف بشكل مفرط أدى إلى ربط معظم وسائل الانتاج الاقتصادي والشراكة السياسية بالمركز، الذي اختصر على مجموعة من مراكز القوى التي احتكرت مقومات الحياة الاقتصادية والسياسية في تلك الدول.
ربما كانت المركزية من إفرازات “العقل المركزي”، وهو عقل أحادي غير قريب من “فكرة التعددية”، وهذا العقل ليس بعيداً عن البنى الفكرية للمجتمعات العربية التي يأخذ فيها الفرد – لا المؤسسة – دوراً محورياً في القيادة اقتصادياً وسياسياً ومجتمعياً، وهو عقل له امتداداته في طبيعة المجتمعات القبلية القائمة على واحدية المشيخة القبلية، غير أن المركزية لا تُعَد شراً مطلقاً، فقد يدافع عنها البعض بكونها النمط الأنسب لمجتمعاتنا العربية في الفترة الراهنة، كون هذه المجتمعات لا تزال بعيدة عن اعتناق فكرة التعددية التي كان لها دور في إنتاج التجارب الديمقراطية الحديثة في الغرب الرأسمالي، حيث نجحت التعددية في الحفاظ على الوحدة السياسية والسلم الاجتماعي لكثير من الدول الوطنية في الغرب، في حين ظلت المركزية هي الحامل الأكبر للوحدة السياسية والمجتمعية في الدولة العربية الحديثة.
ومع بعض مزايا المركزية، والتي يرى المدافعون عنها أنها فكرة واقعية مناسبة للمجتمعات العربية، إلا أن تلك الفكرة كان لها دور في العمليات المضطردة التي شهدتها العقود الأخيرة من زحف للهوامش والأطراف على المتون والمراكز، وذلك بسبب تركز الخدمات الأساسية وفرص العمل والتعاملات الإدارية غالباً في العواصم. ومع استمرار عمليات التجريف الديمغرافي لدواع اقتصادية تراكم منسوب إهمال الحرف الريفية بهجران أهل الريف لقراهم نحو العواصم، وهو الأمر الذي ولد ضغطاً كبيراً على المدن الكبرى، وترك الريف بلا تنمية، الأمر الذي ضاعف من منسوب الهجرات الداخلية نحو المراكز، ما أدى إلى إهمال الزراعة لصالح مهن أخرى، وكان لهذا – بطبيعة الحال – دوره في إعادة تشكيل أنماط السلوك وطرائق التفكير ومذاهب الإبداع، وهي البُنى الفوقية عند كارل ماركس، والتي تتأثر بالبُنى التحتية المادية وعلاقات الإنتاج.
وخلال العقود الأخيرة أدى زحف الريف على المدينة إلى مراكمة مستويات معيشة متفاوتة وتشكيل شرائح ريفية كبيرة على هوامش المدينة وفي الضواحي التي ازدادت فقراً ونقصاً في الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وغيرها مع مرور الوقت، رغم قربها من المركز الذي يرونه في أوضاع معيشية مختلفة نسبياً، الأمر الذي راكم لدى أبناء تلك الشرائح نوعاً من النقمة المكبوتة ضد المدينة بما تعنيه من سلطوية مركزية، وهي النقمة التي لم تدم كثيرا حتى انفجرت مطلع العام 2011 في عدد من البلدان العربية، فيما عرف حينها باسم “ثورات الربيع العربي”، الذي كان نتاج الصراع الخفي قيمياً ومادياً بين الريف والمدينة أو بين الهامش والمتن، على خلفية زحف الهوامش القصية على المتون المركزية.
تفجرت موجات الربيع وانهار المركز على وقع الهدير العنيف الذي انفجر بفعل صراع الريف الذي يرمز للفقر والتهميش من جهة والمدينة التي ترمز للغنى والاستحواذ من جهة أخرى، ورغم أن الربيع العربي تفجر في المدن إلا أن ذلك لا يعني أن المدينة بأبعادها الاقتصادية والسياسية هي التي أنتجته، بل إن الريف بدلالاته الرمزية هو المنتج الفاعل لهذا الربيع الذي أسهمت شرائح ريفية واسعة في تفجيره بمشاركة شرائح متمدنة رأت في التغيير ضرورة لا بد منها.
واليوم، عندما نطالع خرائط مراكز القوى الجديدة في بلدان الربيع العربي نجد أن تلك المراكز المتشكلة هي مزيج من قيادات النظم السابقة وإفرازات ثورات الربيع، في اختصار بليغ لحقيقة الصراع على الموارد بين قيم وأنماط التفكير المختلفة والمنتمية لكل من الأرياف والمدن، مع ملاحظة بروز الأرياف في التشكيلات الجديدة بقوى صاعدة تبحث عن نصيب من الكعكة التي أكلت الحرب معظمها.
كان ابن خلدون يؤكد أن الدولة تقيمها العصبية القائمة على رابطة الدم، وهذه فكرة ريفية خالصة، في مقابل قيام مجموعة العلاقات المدنية على أساس نفعي لا جيني، بسبب طبيعة المجتمع المدني المكون من “أخلاط” من الناس تربطهم مصالح مشتركة، فيما تقوم العلاقات المجتمعية في الأرياف على روابط الدم، بسبب حاجة المجتمع القبلي إلى تلك الرابطة للدفاع عن وجود القبيلة، وهو ما أدى إلى ارتباط الريفي بالعرق أكثر من ارتباطه بالأرض، وهي الحال المغايرة لنظيرتها في المدينة، حيث يميل الناس للارتباط بالأرض، أكثر من أية ارتباطات جينية أخرى.
من هنا يسهل على الريفي مغادرة قريته، كما يسهل على البدوي مغادرة باديته، وهو ما يدفع بالهجرات البشرية الداخلية أو الخارجية للتوجه نحو مراكز الحضر، في رحلة تتحول فيها طبيعة العلاقة من الارتباط بالجين إلى الارتباط بالطين أو من العرق إلى الأرض، نظراً لتحول طبيعة الأهداف من المحافظة على القبيلة إلى المحافظة
على المصلحة. ومن هنا تتوالى موجات الهجرات التي تظل في بداياتها محتفظة بروابطها الريفية الجينية في المجتمع المدني الجديد القائم على روابط نفعية مدنية، الأمر الذي يسرع من وتيرة الاحتكاك بين منظومتين قيميتين ومجتمعيتين مختلفتين، ومن هنا يتم التأسيس لفكرة انهيار المركز على يد محيطه، أو تصدع المتن بسبب زحف هوامشه التي تبدأ مع الزمن رحلتها لكي تكوّن متناً جديداً يقوي فكرة المركزية، ويتقوى بها، ليعاد تشكيل منظومة العلاقات بين الريف والمدينة أو بين الهامش والمتن أو الأطراف والمركز في منظومات سياسية واقتصادية وفكرية وقيمية جديدة.
ووفقاً لتلك التصورات فإن استقرار الدولة الوطنية في الوطن العربي قائم على أساس رسم قواعد عادلة للعلاقة بين الهوامش والمتون، وهي القواعد التي تحافظ على توازن العلاقة بين ديموغرافيتي الريف والمدينة، بما يقتضيه ذلك من خلق بيئة مناسبة توفر للريف فرصة الاستقرار بما لا يدفعه للزحف على المدينة وإحداث خلل في المنظومتين المختلفتين.
يقتضي ذلك القيام بإصلاحات اقتصادية يكون في مقدمة أهدافها منع تكدس المواطنين في بقعة جغرافية مكتظة، الأمر الذي يؤدي إلى خلل في وسائل وعلاقات الإنتاج، وهو في الغالب السبب الجوهري لأية ثورة أو اضطراب في أي بلد، ويتم تحقيق هذا الهدف عبر موازنة تؤدي إلى عدم إهمال القيم الإنتاجية في الريف الزراعي لصالح قيم إنتاج أخرى تركز على بيئة المدينة التجارية.
هذا التوازن بين البيئتين الجغرافيتين أو المنظومتين الإنتاجيتين أو النمطين القيميين هو الذي يحافظ على المنظومة السياسية متوازنة ويجعلها تعكس إرادة جميع مواطنيها بعيداً عن المركزية المفرطة التي تؤدي إلى شعور الأطراف بالتهميش، وهو الشعور المحرض على الثورة وعدم الاستقرار.
وفي نظرة سريعة إلى تشكيلة مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يمكن ملاحظة عملية حيوية لإعادة صياغة علاقة الريف والمدينة، بما يعكس تطبيقاً تلقائياً للأفكار المذكورة في هذا المقال، فقد حضرت في تشكيلة المجلس شخصيات قادمة من أقاصي الهوامش المعارِضة، سواء كانت تلك الهوامش ريفية أو مدينة، كما وجدت شخصيات تعكس تجليات المركزية السلطوية بشكل أو بآخر، سواء كانت تلك المركزية ريفية مجتمعية أو مدينة سياسية، وهذه النموذج اليمني يمكن ملاحظته كذلك في عدد من الدول العربية التي تمر بمرحلة عدم استقرار، الأمر الذي يكرس حقيقة أن استقرار المنظومة السياسية في بلد ما هو إلا انعكاس لاستقرار المنظومة الاقتصادية، وهذا الاستقرار الاقتصادي ناتج عن علاقات إنتاج عادلة ومتوازنة تؤدي إلى توفر أسباب العيش الكريم للشرائح المجتمعية المختلفة، وبما يضبط العلاقة بين الريف بخصائصه الزراعية والمدينة بسماتها التجارية، عن طريق توفير فرص العمل المناسبة في حقل الفلاح كي لا يهجره إلى المدينة لمنازعة التاجر في متجره، وبما يضمن حضور التمثيل المتوازن بين الريف والمدينة في المنظومة السياسية محلياً ومركزياً، كي لا يحدث الخلل الذي يمهد لانقضاض الهوامش على المتون، في ثورات لا تنتهي.